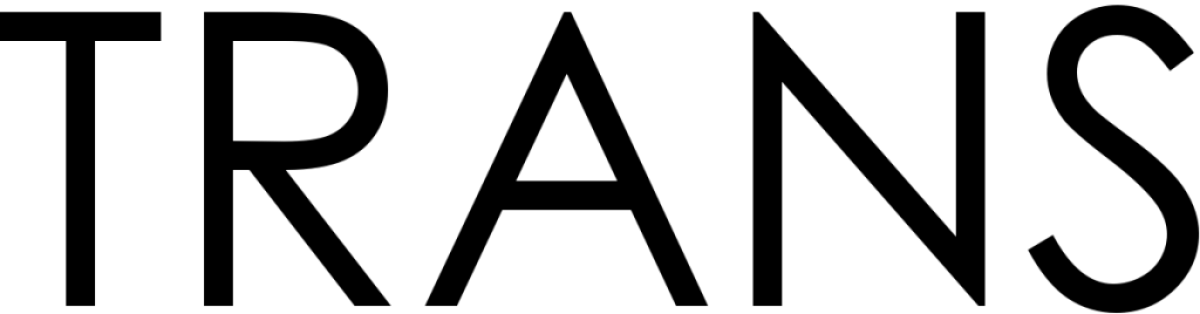Dr. Nawel Hamadouche
University Setif 2, Mohamed Lamin Dabbaghin
Abstract
In this intervention, we will attempt to focus on the economic importance of language within Algerian society and on the impact of various economic factors on linguistic development, not far from the axioms of the social and psychological importance of language.
Given the fact that the latter is interested in dealing with many practical branches, which demonstrate its paramount importance for human existence as a whole, it will be discussed, under an economic view;which can not be reduced to other facets. To a high degree, the physical conditions of the life of their owners.
Because languages are used by their communities as tools and means, there are reciprocal relations between language and community. This non-simple relationship emphasizes the development and development of languages but is influenced by the way in which human societies interact with their physical, social, economic and cultural environments. On the contrary, basic features of certain languages have an impact on the way users relate to these environments.
Within this intervention, theoretical answers to questions such as:
• Can the language be considered as a cash balance?
• Does the phenomenon of multilingualism in a society cost a high price?
• Is there indeed a relationship between the disparity in the distribution of languages in multilingual societies and economic inequality?
• Is the single language economically useful?
• Is there a relationship between language adaptation and language differentiation and integration?
Which requires comparisons between the linguistic system and the economic system, examining the dynamics of expanding markets and languages, and the emergence of unified and common European languages coincided with the emergence of common currency and common markets and their impact on national markets.
And the presentation of a number of huge and parallel changes, which occurred at the level of customs or means of communication or business. In the same language has become a commodity, directed to language markets, with a regional and global dimension.
مقدمة:
يعتبر موضوع اللغة، من المواضيع التي اهتم بتناولها فروع عملية كثيرة، الأمر الذي يدلل على أهميتها القصوى بالنسبة للوجود الإنساني ككل، سيتم مناقشتها ، تحت وجهة نظر اقتصادية، التي لا يمكنها أن تكون اختزالية للوجهات الأخرى، وإنما تسمح بتصور الصلات المتبادلة بين اللغة، لوصفها بنية مجردة بدرجة عالية، والظروف المادية لحياة أصحابها .
وبما أن اللغات توضع في الاستعمال من طرف جماعاتها، باعتبارها أدوات ووسائل، فإن هناك علاقات متبادلة بين اللغة و الجماعة. هذه العلاقة التي توصف بغير البسيطة، حيث تؤكد على أن تكون اللغات وتطورها، إنما يتأثران أيم تأثر بالطريقة التي تتفاعل بها المجتمعات الإنسانية مع بيئاتها الفيزيقية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأنه على العكس، فإن ملامح أساسية للغات معينة ، لها تأثير في الطريقة التي يتصل بها مستعملوها بهذه البيئات.
سيتم ضمن هذه المداخلة محاولة إيجاد أجوبة نظرية لأسئلة مثل :
-
هل يمكن تحليل اللغة كظاهرة اقتصادية؟
-
هل يمكن اعتبار اللغة كرصيد من النقود ؟
-
هل تعلم اللغات الأجنبية هي حاجة اقتصادية ملحة؟
والتي سيتم بموجبها عقد مقارنات بين النظام اللغوي و النظام الاقتصادي، وفحص من خلالها دينامكيات توسيع الأسواق ونطاقات اللغات، وظهور اللغات الأوربية الموحدة والمشتركة تزامنا مع ظهور العملات القياسية الموحدة والأسواق المشتركة وأثرها على الأسواق الوطنية.
وإبراز معاينة عدة تغيرات ضخمة ومتوازية، حدثت إن كان على مستوى العادات أو الوسائل الاتصالية أو التجارية.بشكل أصبحت فيه اللغة نفسها سلعة، توجه لأسواق لغوية، ذات بعد إقليمي وعالمي.
وإن حالات التنافس بين السلع، يمكن إسقاطها أيضا على اللغات، فهذه الأخيرة تكسب أو تخسر متحدثين عند انتقالها من جيل لأخر، ومنه فانتشار اللغات يدل على فائدتها ونجاحها الاقتصادي، الذي يعتمد في الأساس على الظروف الاجتماعية لجماعاتها اللغوية الخاصة. ومن ثم فتنافسها يعتمد أيضا على صلاحيتها، طرق ومدى تكيفها مع المتطلبات الاتصالية لمتحدثيها.
ثم إنه، وفي سياق قياس الهوة المطردة الاتساع بين البلدان النامية والمتقدمة اجتماعيا، اقتصاديا، علميا وتكنولوجيا، وأهمية الضغط الذي تمارسه هذه الأخيرة، والذي لا تملك مجموع البلدان الأقل تقدما سوى التكيف، يمكن إسقاط كل ذلك على المستوى اللغوي، فهناك لغات كثيرة تعاني من نواحي قصور شديد، فيما يتصل بالمتطلبات الوظيفية للاتصال ، فبالرغم من قيمتها بالنسبة لمستعمليها، إلا أن استعمالها كثيرا ما يقل كثير من طرف متحدثيها، ومن ثم تسجيل تناقص ذخيرتها الاتصالية، وليس وراء ذلك، سوى عامل فائدة اللغات الاقتصادية، ذلك لأن أحد مكونات الفائدة الاقتصادية للغات: هو اقتصادها الداخلي، الذي ينجم عن احتياج البشر إلى استعمال الوسائل في إنجاز الاتصال على نحو اقتصادي.
أولا : في ماهية التحليل الاقتصادي للغة :
-
في ماهية التحليل الاقتصادي:
يعتبر التحليل الاقتصادي أحد أجزاء علم الاقتصاد، وهو منهج علمي نستطيع من خلاله تفسير العوامل التي تؤثر في سلوك الظواهر الاقتصادية، ومن خلاله نستطيع أن نستمد الأدوات المنطقية، لكي نستخدمها في استنتاج النظريات الاقتصادية المختلفة، ويتم هذا الأمر من خلال إعادة الظاهرة الاقتصادية إلى العناصر البسيطة، ومن ثم تتم صياغة الفرضية التفسيرية على أساس العلاقة التابعية أو السببية1.
ويعتمد المنهج الاقتصادي على الاستنتاجات المنطقية والاستنتاجات التطبيقية، ولقد مر علم الاقتصاد بمراحل عديدة حيث اقتصر في بداية الأمر على مشاهدة الظواهر الاقتصادية وتدوينها دون محاولة تحليلها أو تفسيرها، وبقي علم الاقتصاد على هذه الحال إلى أن ظهرت المدرسة التقليدية (الكلاسيكية)، والتي أنشأها (آدم سميث)، واستخدم الاقتصاديون الرياضيات وعلم الإحصاء لفك العقد في الظواهر الاقتصادية، وبذلك أصبح التحليل الاقتصادي هو الوسيلة الوحيدة لتطوير علم الاقتصاد، وبذلك انتقل هذا العلم من مجرد مراقبة الظواهر الاقتصادية إلى تحديد سيرها والتحكم فيها2
2- في ماهية التحليل الاقتصادي للغة:
يقوم التحليل الاقتصادي للغة في النظر إليها على أنها أداة في الاقتصاد وفي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول والأمم، إذ يعدّ استعمال اللغة بمردود جيد وكفاية عالية أساساً لتحقيق الاقتصاد المعرفي و من ثم النمو الاقتصادي ككل ، كما يعتبر ضرورياً في عملية التنمية3.
كما ينظر لها وفقا لهذا التحليل: على أنها صناعة وسلعة في القطاع الاقتصادي، إذ تزايد دور الصناعات الثقافيّة وقاعدتها اللغة في الاقتصاد العالمي مؤخراً تزايداً كبيراً جداً.4
في دراسةٍ أجراها البنك الدولي ضمّت عيّنتها أكثر من ستين دولة وبالإضافة لأكثر من ستين ألف جهة مختلفة، خلصت إلى أن حاجة الدول النامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي تكمن في رفع مستوى المعرفة لأفراد المجتمع لا في مساعدات إنسانية، وهذا ما لا يتمّ الحصول عليه إلا من خلال اللغة الأم. وقد بينت أيضاً، أن للمجتمعات رصيداً أو ثروة نقديّة، ولها أيضاً رصيد أو ثروة لغويّة، وكلّ من العملة واللغة تصك، ويعتنى بتنظيم صكها، ولا تترك من دون تحكم ومتابعة من الدولة، وتأتي قيمة النقد وكذلك قيمة اللغة من تداولها، فإذا أهملت الدولة التداول بعملتها أو بلغتها (التعليم بغير اللغة الوطنية) فإن لهذا آثاراً اقتصادية هائلة5.
وعن الأبعاد الاقتصادية للغة فهي تتجلي في6:
1 – المجال الاتصالي للغة كما تعبر عنه القدرة السكانية (الديموغرافية) للجماعة التي تستعملها بوصفها (أ) لغة أولى و(ب) لغة ثانية أجنبية.
2- مستوى تطور الإمكان الوظيفي للغة باعتبارها أداة إنتاج مجتمعية ومستوى الفرص المتعلقة باستخدامها.
3 – الطلب عليها بوصفها سلعة في السوق الدولية للغات الأجنبية، وحجم الصناعة التي تمده، والحصص المخصصة من النواتج القومية الإجمالية التي تنفق على الصعيد العالمي لاكتسابها.
4- رصيد الحساب الجاري للغة بالنسبة لجماعتها اللغوية.
5– المقدار الكلي للاستثمار الموضوع في اللغة حيث يمكن للتدوين
المعجمي وكثافة شبكة المعاجم ثنائية اللغة التي تربط اللغة باللغات الأخرى، والترجمة من اللغة وإليها، ومستوى إمكان المعالجة الالكترونية، أن يستخدم ذلك كله مؤشرات جزئية.
6 – الاستثمار في اللغة من خلال توجيه رأس المال نحو الاستثمار في معالجة اللغة إذ يتوقع عائداً كبيراً للمستثمر نفسه وللغة أيضاً، وذلك للأسباب التالية:
-
قابلية هذه الاستثمارات للنمو نظراً لاتساع سوق اللغة، وتزايد الطلب على برامج المعالجة اللغوية.
ب– مرونة اللغة وقدرتها على استيعاب التقنيات المختلفة لتعدد خصائصها وتفردها، مما يجعلها حقلاً خصباً للدراسات التنظيرية اللغوية بصفة عامة، وهو ما يضمن رواجاً لها في حركة البيع والشراء فالمعاجم اللغويّة بالرغم مما تتطلبه من استثمارات أكثر ضخامة من معظم الكتب، ولكنها تعد بدخل أكبر وأكثر بقاء، وتساعد المعاجم على التوحيد اللغوي، ذلك لأن معاجم اللغة الواحدة تجسد مفردات اللغة وتحولها إلى ملك مادي محتمل لكل عضو في الجماعة اللغوية. ويعد قاموس أوكسفورد معجماً تاريخياً فريداً للغة الإنجليزية، ولن يكون عملاً خاسراً للناشر على المدى البعيد على الرغم من التكلفة الضخمة التي أنفقت عليه، وهو إغناء كبير للغة الإنجليزية وزيادة مستمرة لقيمتها وتطويرها بوصفها أداة إنتاج».
ج – الترجمة بدورها وباعتبارها استثماراً طويل الأمد من أجل الحفاظ على قيمتها أو
زيادتها، ولما كانت كل ترجمة إلى لغة تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إلى مجمل كل
الترجمات إلى لغة ما باعتباره مؤشراً آخر إلى قيمتها. وإن حركة الترجمة إلى لغة ما
تكشف عن مقدار العمل النوعي الذي يمكن لمجتمع أن يخصصه لهذا النوع من المهن».
وفي مجال تعلّم اللغات الأجنبية: «تكشف الطبيعة السلعية للغات عن نفسها بشكل
أوضح في مجال تعلم اللغة الأجنبية وتدريسها الذي يمكن وصفه باعتباره سوقاً.
وهنا يمكن التمييز بين سوق محلية وسوق إقليمية وسوق وطنية وسوق عالمية».
ثانيا: في كون اللغة كرصيد من النقود.
تعد المماثلة بين الرصيد اللغوي والرصيد المالي قديمة زمنيا، فقد كان (جون لوك) أول من وصف الكلمات باعتبارها „القاسم المشترك للتجارة والاتصال“ وهو قاسم لا يمثل ملكية خاصة لأي إنسان، كما „أن النهج الذي تسير عليه الكلمة لا يخضع تغيره لمشيئة أي شخص„. ومن دون تفعيل ما سبق، يصف (لوك) ماهية اللغة بأوصاف يمكنها أن تنطبق على ماهية المال .7
تماما فعل(ليبينتز) وبعده (دافيد هيوم) و (يوهان جورج هامان) وغيرهم من الكثيرين اللذين توصلوا ومن خلال تبني التفكير ضمن مقاربة اقتصاديات التربية بأن اللغة ليست قيمة في حد ذاتها، وإنما تنطوي على القيمة. هذه الأخيرة التي تكون اقتصادية بالأساس، والتي من الممكن أن تضفي قيمة مضافة كبيرة على الاقتصاد القومي.8
وعليه، فاللغة هي أداة – مثل النقود – تنطوي على تسهيل تلبية خيارات الأفراد وتوسيع مجال الفعل لديهم. فإذا كانت النقود وسيطاً للتبادل فإن اللغة تسهل التبادل؛ وبالتالي تضيف اللغة قيمة اقتصادية إلى حائزيها مما يجعلها تحتاج إلى وضع معايير لتحديدها.
فتلتقي، وبناء على ما تقدم – اللغة بالاقتصاد ويتقاطعان في مكوناتهما التعريفية ففي التعريفات باللغة، نجدها بأنها قدرة كامنة تجعل الفرد قادراً على تحقيق ذاته، وهو بالمقابل أحد تعاريف الاقتصاد والعملة على وجه التحديد.
يذهب علماء الاجتماع، إلى أن هناك توازياً بين تطور اللغة وتطور العملة، وتشابهاً بين استخدام الكلمات واستخدام النقود، خاصة وأن كليهما يستمد قيمته من التبادل، وأنهما لكليهما قيمة وحاجة اجتماعية، وأنهما كليهما نظام اجتماعي.
بينما يذهب علماء الاقتصاد، وبالمقابل، إلى أن اللغة هي القاسم المشترك للتجارة والاتصال، ومن ثم فهي عنصر من عناصر الازدهار الاقتصادي، فقد دلت الدراسات على أن متوسط دخل الفرد يتدنى في البلاد التي تتعدد فيها اللغات مقارنة مع البلاد التي يقل فيها هذا التعدد، اذ يكفي ملاحظة عدة بلدان كبريطانيا أين يزيد معدل دخل الفرد عشرات المرات عن الفلبين، ذلك بالرغم من تقارب عدد السكان بسبب تعدد اللغات في الفلبين، ولذلك يكتب العلماء:“ إن البلاد المجزأة لغوياً بشكل كبير بلاد فقيرة دائماً».
ثم إن التوزيعات والترتيبات، بل وحتى الصراعات اللغوية اليوم، تتوازى وتتقابل بشدة مع ترتيبات وصراعات العملات، فالمواجهة بين الدولار، الأورو والين: هي الوجه الآخر لصراع لغات، ثقافات وحضارات أوروبا، أمريكا واليابان .
لذلك يتم الإجماع من طرف العلماء بأن اللغة بالنسبة لاقتصاد السوق مسألة محورية. وتنشأ أهميتها الكبيرة من كون النشاط الاقتصادي يعتمد على الاتصال بدرجة كبيرة، وأن العناصر الأساسية للاتصال الاقتصادي عناصر لغوية.
ومنه، لن يستطيع الفرد إنتاج العمل في الأسواق دون تمكنه من أداة لغوية معينة، هي لغة سوق العمل الذي يرغب العمل فيه، لتكون المعرفة القاصرة للفرد بلغة سوق العمل شبيهة إلى حد بعيد بوضعية عدم توافر رأس مال نقدي لدى رجل الأعمال الذي يريد إنشاء مشروع معين.
وعلى الرغم من عدم وجود نشاط اقتصادي من دون اتصال، فإن الاتصال يستلزم نفقات ترجع جزئياً إلى التعدد اللغوي في العالم. وسواء كان هناك فهم اقتصادي أم لا، فإن الاستثمار في لغة معينة لغرض أو لآخر هو مسألة بذل جهود موازاة مع دفع نفقات من أجل الحصول على أرباح. وفي هذه المعادلة، الكثير منها ما ينطبق على اللغة، باعتبارها هي أيضا تتطلب نفقات استثمارية كبيرة لتعلمها؛ للوصول إلى جني أرباح من وراء تعلمها.
يكتب أحدهم إن تحليل البعد الاقتصادي للغة ليس بهذه السهولة؛ فقد يصبح صرف أموال عامة في بعض اللغات خياراً غير رشيداً وفقاً لآلية “ النفقة – العائد „؛ لأن هذا الاستثمار لن يحقق أو يعد بتحقيق عوائد اقتصادية مناسبة في حالة انخفاض القيمة الاقتصادية للغة في السوق الدولية للغات. ويصعب على الدولة حين ذلك إيجاد مبرر اقتصادي لشعبها لصرف أموال عامة في لغة لا تعد بتحقيق عائد مناسب. وهنا يستند دعم اللغة إلى البعد الآخر لها وهو قيمتها الثقافية كمبرر لقرار الإنفاق الذي قد يسير في اتجاه مضاد لمنطق السوق9.
وهنا يمكننا الاستعانة بمثال مفاده، أنه بالرغم من تزايد القيمة الثقافية للغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ولغة الضاد، إلا أن قيمتها الاقتصادية تتأخر كثيراً مقارنة بكثير من هذه اللغات. فرجال الأعمال الخليجيين – على سبيل المثال – لا يستطيعون أن يتعاملوا في سوق أمريكية من دون تمكن كاف من الإنجليزية، بينما يستطيع رجال الأعمال الأمريكيين القيام بأعمال في دول الخليج دون إتقان اللغة العربية.
وهذا إن دلَ على شيء، فإنما يدل على أن القيمة الاقتصادية للغة الإنجليزية في السوق الخليجية أكبر من القيمة الاقتصادية للغة العربية في السوق الأمريكية.
ومن ثم فاللغات تخضع لبورصة تماما كما بورصة العملات، إذ وبالرغم من تواجد نحو سبع آلاف لغة منطوقة في العالم كما يحاول إثباته عالم اللغات الفرنسي الكبير (لويس جان كالفي)10 ، إلا أنها من حيث الأهمية والتأثير في ظل العولمة هناك ممن ذات قيمة مرتفعة، دون البعض الآخر المنخفضة القيمة.
ولعل تحليل (كالفي) لأوزان اللغات يشير إلى «بورصة» من نوع مختلف حيث يعتمد على مقياس مركب يشمل عدد المتكلمين باللغة بوصفها لغة أولى أو «لغة أما»، وعدد البلدان التي تكون اللغة فيها رسمية، ومعدلات الكتب المترجمة من اللغة وإليها، والموقع الذي تحتله على شبكة «الانترنت»، والوزن الاقتصادي للبلدان التي تتكلم اللغة.
ووفق هذا المقياس، يشتد التفاوت بين اللغات. وينطوي هذا التفاوت على احتكار على النحو الذي يحدث في الاقتصاد، بل قد يكون أشد حيث تحتكر 5% من اللغات نحو 94% من «السوق» أو سكان العالم، أي أن 6% فقط من البشر يتداولون 95% من اللغات.
ومثلما تخسر شركات وتُفلس في السوق الاقتصادية، تنقرض لغات تكون حية اليوم ثم تموت غداً عندما يتوقف استخدامها وسيلة للاتصال11.
هذا ويوضح آخر تقرير صادر عن منظمة اليونسكو الدولية أن نصف اللغات المحلية التي لاتزال حية مهددة بالانقراض أو الموت، بل يرصد اندثار لغة كل أسبوعين، أي موت 25 لغة سنوياً، وان هناك الكثير من اللغات المحلية في أوروبا نفسها مُهدَّدة بسبب زحف اللغة الإنجليزية، مثل اللغة البروتونية فى فرنسا، وبعض اللغات المحلية في إسبانيا وبلجيكا.12
كذلك الترجمة اللغوية13، فهي أيضا لا تسلم من الميزان الاقتصادي، حيث يتشابه ترجمة محتوى من لغة إلى أخرى تبديل سلع عبر واسطة النقود. ليصبح المترجمون كما الصرافون للعملة وسطاء، يقوم الأولون بلعب الوساطة لتحويل نفس الأفكار المعبر عنها في لغة معينة و إعادة إنتاجها بلغة أخرى، ونظرا لأنه لا يمكن للغتين أن تتم مطابقة إحداهما مع الأخرى بطريقة متناظرة تماما كانت الترجمة عملا فنيا وليست نقلا ميكانيكيا خالصا؛ في حين يقوم الصرافون بتبديل العملة والذي عن طريقه يفعلون إمكان التعبير عن قيمة معينة ممثلة في واسطة محددة من خلال واسطة أخرى ، على حد وصف (كارل ماركس ).
ثالثا : في كون تعلم اللغات الأجنبية حاجة اقتصادية ملحة؟
غيرت العولمة من ملامح الحياة العصرية وفرصها، وانتشرت بسببها ظواهر واختفت أخرى، ومن المؤكد أن الانفتاح الواسع الذي حل معها وضع العالم في بيئة اجتماعية وثقافية مختلفة لها متطلباتها واتجاهاتها الرئيسية الجديدة في المجالات العلمية والمهنية، ومن بينها تفشي اللغات الأجنبية في الفصول الدراسية وأسواق العمل.
لسنوات عديدة تعاملت المجتمعات مع هذا الموضوع بطرق مختلفة، ما بين التشجيع والإهمال وذلك لأسباب لها علاقة بالوعي العام والوضع المادي للأفراد، ورغم الإيجابيات التي يشير إليها مؤيدي فكرة إدخال اللغات الأجنبية إلى المناهج التعليمية، فإن هناك جدلاً واسعًا عن مدى أهمية هذه المهارة في العصر الحاليّ وتأثيرها على الثقافة المحلية واللغة الأم.
هذا ويبرر البعض أن انتشار اللغة الإنجليزية في العالم، بالعودة لسهولتها أو مرونة قواعدها، ولكن هذا التبرير ليس صحيحًا بالفعل، فلقد كانت اللغة اللاتينية الأكثر تأثيرًا في أحاديث الناس لأكثر من ألف سنة، بينما يقتصر استخدامها اليوم على الكهنة وداخل بعض التخصصات الجامعية.
والحقيقة أن اللغة الإنجليزية لم تكن منتشرة بالشكل الذي نلاحظه اليوم، فلقد هيمنت على بعض المدارس الأوروبية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، بالجانب مع اللغة الفرنسية التي شكلت جزءًا كبيرًا من جميع أعمال المال والتجارة والتعليم والاتصالات الدولية، لكن مع ازدهار الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديًا بشكل تدريجي في فترة الخمسينيات انتشرت اللغة الإنجليزية بشكل واسع وعرفت آنذاك بلغة التجارة. ومن ثم لم تمتلك اللغة الإنجليزية سوق العمل فقط، بل امتد تأثيرها الثقافي والفني إلى جميع الدول من خلال نجاحاتها المذهلة في مجالي الموسيقى والسينما؛ حتى شاعت ثقافتها في الأنحاء ووصلت إلى شريحة كبيرة من الناس وأصبحت اللغة العالمية، كما تزامنت هذه الشهرة مع ولادة الثورة التكنولوجية التي قادتها أمريكا؛ مما زاد من أهمية لغتها بشكل أكبر خاصة أنها لغة الحواسيب خصوصا والأجهزة التكنولوجية عموما .
الشيء، الذي جعل من هذه اللغة والكثير من غيرها، تعلم في المؤسسات المدرسية، توازيا مع تزايد ترسيخ مبدأ تدريس دراسة اللغات الحديثة كجزء من المناهج الدراسية للمدارس وتطوير أساليب تعليمها اعتمادا على نظريات متعددة لحفظ قواعدها والتدريب على نطقها والتحدث بها.
لتصبح فرصة تعلم اللغات جميعها متوفرة للجميع بغض النظر عن إمكاناتهم المادية أو ظروفهم، وهذا بالطبع بفضل معجزة التكنولوجيا والثورة المعلوماتية التي حفظت لكل فرد حقه بالحصول على المعرفة والتعلم الذاتي.
وان كانت عملية تعلم اللغات تحيل في فترات سابقة للترف الاجتماعي والمستوى المادي الميسور، وتطبعت بصبغة طبقية وخصصت لنفسها مكانة اجتماعية معينة، ليكون المقبل عليها من ذوي الحظوظ ممن لديه القدرة على التسجيل ضمن المدارس الخاصة العريقة والمعروفة بتكاليفها العالية، أو ممن حصل على فرصة السفر خارجًا وتمتع بهذه التجربة بجميع نواحيها اللغوية والثقافية.
فقد باتت في عصر العولمة، من نصيب العام والخاص ممن تعلم في المدارس الحكومية التي حتى وإن افتقدت إلى معايير الجودة والكفاءة المطلوبة لإتقان المهارات اللغوية، إلا أنها تبقى خيارا ممن يمكن تدعيمه بفرص تعلم اللغات ضمن المعاهد الخاصة، أو من خلال البرامج والتطبيقات المتوفرة للجميع بغض النظر عن إمكاناتهم المادية أو ظروفهم. وهذا بالطبع بفضل دمقرطة التكنولوجيا والثورة المعلوماتية التي حفظت لكل فرد حقه بالحصول على المعرفة والتعلم الذاتي.
هذا وتختصر المصالح الاقتصادية والمنافع الربحية التي يمكن الحصول عليها من تعلم اللغات؛ فهذا الأخير يسمح للأفراد بتعزيز حضورهم واستقرارهم داخل السوق المحلي، ومتابعة أخبار العالم والتعرف على الدول الرائدة اقتصاديًا وبالتالي تتاح لهم فرصة نقل تجاربهم الناجحة وفتح مجال الاستثمارات وتنامي العلاقات الاقتصادية بين الدول، وهذه فائدة إستراتيجية تتبعها الصين في الضغط على مواطنيها لتعلم اللغة الإنجليزية لتتبع إنجازات السوق الأمريكي والدولي بصفة عامة.
كذلك تركيا التي طرحت اللغة العربية بشدة مجددًا وأضافتها إلى مناهجها التعليمية كلغة ثانية اختيارية أو من خلال تشجيعها للبلديات على استخدام اللغة العربية في المناطق السياحية والمزدحمة بالسياح العرب، وهذا مؤشر إلى ثقل اللغات في العلاقات الخارجية بين الدول.
ولا شك أن تعليم اللغات يعتبر حلقة وصل بين الأمم، فهي تمنح المجتمع صفات حضارية تجعله أكثر انفتاحًا على العالم وتقبلًا لعاداتهم وتقاليدهم، وتزيل الحواجز بينهم وبين العالم الخارجي بسبب التجارب والمعرفة المتبادلة، وهذا ما أشارت إليه الروائية الأمريكية،(ماي براون) عندما قالت: „اللغة هي خريطة طريق الثقافة، ستخبرك من أين أتى أناسها، وإلى أين سيذهبون„.
فمع التطورات السريعة التي شهدها عصر التكنولوجيا، يبدو تعلم لغة الآلة أو البرمجة أمرًا منطقيًا عند النظر إلى عدد المبرمجين الذي وصل إلى 18 ألف مليون مبرمج.
ومن ناحية أخرى، تساعد اللغات الجديدة الفرد على استخدام إدراكه العلمي بشكل مختلف، وينمي قدرته على فهم التراكيب والقواعد اللغوية ويزيد من مرونته الفكرية وأمكاناته على التحليل والتواصل، وهذا ما أكد عليه رائد الفضاء جيوفري ويليامز عندما قال: „لن تستطيع أبدًا فهم لغة ما حتى تتمكن من فهم لغتين على الأقل„، أو ما قاله الأديب الألماني (يوهان فولفغاتغ فون غوته): „أولئك الذين لا يعرفون أي لغات أخرى، لا يعرفون شيئًا عن لغتهم الأم„، ولا بد أن هناك الكثير من المتع اللغوية التي يفتقد إليها الأشخاص الذين يتحدثون لغة واحدة.
إلى ذلك، فإن جميع هذه التأثيرات والمتطلبات ألغت الحدود الجغرافية بين الناس وراهنت على قوة اللغة وقدرتها على الوصول إلى أبعد بقعة وتوحيد العلاقات الدولية، ومع التطورات السريعة التي نشهدها في عصر التكنولوجيا يبدو تعلم لغة الآلة أو البرمجة أمرًا منطقيًا عند النظر إلى الإقبال على تعلم لغة البرمجة.
فبحسب إحصاءات المركز العالمي للعاملين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصل عدد المبرمجين إلى أكثر من 18 مليون مبرمج، وهذا بالتوافق مع رغبة العالم في محاربة الأمية التكنولوجية وتحسين قدرة الأفراد على التواصل مع الآلات التي يرجح أنها سوف تسيطر على مجالات عديدة في عالمنا يومًا ما.
وعليه، لا يمكننا إلا استنتاج أن اللغة بالنسبة للاقتصاد الحديث ضرورة و آلية عمل أساسية، أي اقتصاد السوق في مقابل اقتصاد المعيشة، مسألة محورية مثل النقود، وتنشأ أهميتها الحاسمة من كون النشاط الاقتصادي يعتمد على الاتصال بدرجة كبيرة للغاية وأن العناصر الأساسية للاتصال الاقتصادي عناصر لغوية وعلى الرغم من عدم وجود نشاط اقتصادي من دون اتصال، فإن الاتصال يستلزم تكاليف ترجع جزئياً إلى التعدد اللغوي في العالم. 14
فالقرار الذي يتخذ سواء من الفرد أو المؤسسة سوف يعتمد في الغالب على التكاليف النسبية للبدائل حيث يمكن افتراض أن القوة الاقتصادية للغات المستخدمة تقوم بدور مهم.
والاستثمار في اللغة بوصفها رأسمالاً إنسانياً أو بوصفها سلعة تحتاج إلى اعتماد مالي بقدر كبير أو صغير وسواء أكان هناك فهم اقتصادي أم لم يكن على الإطلاق، فإن الاستثمار في لغة معينة لغرض أو آخر هو مسألة تكاليف وأرباح، ووضع هذه المسألة في الاعتبار أمر أكثر أهمية بالنسبة للمشروع الفردي ، الجماعي مما هو بالنسبة للحكومات.
اللغات – إذن، قابلة للتقويم على نحو اقتصادي، حيث يتم تبادلها في السوق، وتحتاج إلى الإنفاق عليها، كما أنها بسبب اختلافها تمارس تأثيراً في العملية الاقتصادية، ولكنها تتأثر بها أيضاً، كما أنها تستجيب إلى الاحتياجات الاقتصادية.
ومن ثم فانتشار اللغة كثيراً ما يكون علامة على الظروف الاقتصادية، وفي بعض الحالات يكون نتيجة للتطورات الاقتصادية لأن تغيّر أوضاع الاقتصاد يجبر المجتمعات على أن تعدل ذخيرتها الكلامية وأنماط اتصالها.
والقول إن المرء الأكثر تعلّماً هو الأكثر ثراء ليس أصح من القول إن البلد ذا المعدل الأقل في الأمية يملك أعلى متوسط دخل فردي، فهؤلاء الذين بصعوبة يكتبون أسماءهم ليست لديهم فرص اقتصادية أفضل على نحو أكبر من هؤلاء العاجزين عن الكتابة تماماً. وعلى المستوى الاجتماعي فإن الثراء لا يعني المعرفة العامة بالقراءة والكتابة.
إن الكتابة – بوصفها وسيلة لإبقاء اللغة، تجسِّد أول ثورة اتصال في التاريخ الإنساني، فالإنسان منذ أقدم العصور لم يستغن عن هذه الوسيلة القيمة، والمرحلة المبكرة للمجتمع المتعلم لا تزال مفيدة من أجل فهم صحيح للجوانب الاقتصادية للاتصال اللغوي، ومنذ البداية كانت الصلة بين الاقتصاد واللغة المكتوبة صلة ذات تأثيرات متبادلة.
وعلى المستوى الاجتماعي وُجدت اللغة المكتوبة وانتشرت استجابة للاحتياجات الاتصالية المتأصلة في الاحتياجات الاقتصادية، وبفضل تجاوزها لحيزي المكان والزمان فهي تمكِّن الفرد والمجتمعات الاجتماعية من مدّ مجال الاتصال إلى ما وراء المحيط المشترك للمتعاملين الموجودين معاً.
ومن ثم، فقد باتت اللغة في حد ذاتها تُعدُّ شرطاً أساساً للحياة الاجتماعية، وكل لغة هي نتاج للحياة الاجتماعية. وعلم الاقتصاد هو البحث عن مؤشرات أمثلية الكفاءة لعلاقات الوسائل – الغايات في أداء المهام؛ وبما أن كل اللغات تستعمل استعمالاً غائياً بوصفها وسائل لغايات معينة، فكل لغة يمكن أن تقوّم بالنظر لمزاياها في إنجاز هذه الغايات، وبالتالي تكون خاضعة لتحليل اقتصادي اتصالي، أي البحث عن أنظمة الاتصال الأكثر مناسبة لسُلّم قيم معيّن.
وهذا الفرع من اقتصاديات الاتصال واقتصاديات اللغة فرع معياري على نحو ضمني بما أنه يتعامل مع أنظمة نموذجية وليس مع أنظمة واقعية، فهذا البحث يُعنى بالخصائص التي تملكها لغة معينة لسد متطلبات معينة كما تحدِّدها سياسة لغوية مقررة على سبيل المثال.
كتب (فلوريان كولماس)15 في كتابه „اللغة والاقتصاد„: اقتصاديات اللغة تعالج الأنظمة الفعلية، ومركز اهتمامها هنا هو: لماذا تكون لغات معينة على ما هي عليه أي لماذا تسود خصائص معينة ولا تسود أخرى.
وعلى رغم أن هذه المقارنة تقوّم الأنظمة الفعلية وليس المخططة، فإنها تُعنى أساساً بالنوع نفسه من المؤشرات، أي تلك المؤشرات التي تحدِّد فعالية النظام. وشروط الفعالية من هنا لا تختلف في النوع عن شروط الكفاءة، وبهذا المعنى فإن مسألة فاعلية لغة معينة يمكن فهمها باعتبارها مسألة اقتصادية.
إذ علم اللغة لا يكون معقولاً بشكل موضوعي من دون مفاهيم اقتصادية، وهذا ما أثبته (بورديو) من بين آخرين على نحو لافت للنظر ؛ لذا يمكن التمييز بين مفهومين لغويين للقيمة، كل منهما مأخوذ على نحو مجازي من المفهوم الاقتصادي الأصلي على رغم اختلافهما في المضمون.
وأول تمييز يجب أن يقام هو التمييز بين المفهوم الوصفي والمفهوم المعياري: فالمفهوم الأول يتصل باللغة بوصفها نظاماً رمزياً، والمفهوم الأخير يتصل باللغة بوصفها مسألة اجتماعية. وبناء على هذا فإن المفهوم الوصفي للقيمة يمكن أن يُعزى لمجال علم اللغة فحسب، بينما ينتمي المفهوم المعياري للجهاز المفاهيمي للعلوم المختلفة التي تعالج استعمال المجتمع للغة.
وعلى مستوى النظام اللغوي فإن الاقتصاد كثيراً ما وضع أو بالأحرى تأكّد بوصفه مبدأ مكوِّناً، أي الاقتصاد في الأدوات التشكيلية المستخدمة في تمثيل معنى معين.
وقد كرّس له (بول) فصلاً من أفضل فصول مؤلفه الكبير بعنوان „اقتصاد التعبير“ حيث يقول: سواء استخدمت الوسائل اللغوية باقتصاد أو بإفراط فإن هذا يعتمد على الاحتياجات، ولا يمكن إنكار أن هذه الوسائل كثيراً ما تستعمل بإسراف، ولكن كلامنا، على العموم، يحمل ملامح اقتصاد معين.16
و(يسبرسن)، مثل (بول)، يعزو لاقتصاد التعبير دوراً مركزياً في تفكيره عن طبيعة اللغة، فالتغيّر اللغوي، في رأيه، هو أساساً مظهر للميل العام نحو الاقتصاد في الجهد، ولكن على عكس(بول)، كان (يسبرسن) أكثر اهتماماً بالنظام اللغوي. إذ معيار البساطة – مثلاً، هو تنوّع جديد على قيمة قديمة هي قانون الاقتصاد الذي نادى به (سكولاستيّو)، وهو القانون الذي يتطلب الاقتصاد في صياغة النظر 17
وهكذا و كمحاولة للختم : نتلمس الأهمية الاقتصادية للغات وتأثير العوامل الاقتصادية في التطور اللغوي، مما يستدعي مزيد اهتمام من قبل علماء اللغة وعلماء الاقتصاد ورجال السياسة والمخططين اللغويين في البلدان النامية، وبشكل خاص البلدان متعددة اللغة.
هوامش المقال:
: الموسوعة العربية ( النسخة الإلكترونية) ، „علم الاقتصاد„، نقلا عن الموقع:
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=465الذي تمت زيارته في 02/01/2018، على الساعة العاشرة ليلا.
2: رفعت محجوب، الاقتصاد السياسي،ج1، دار النهضة العربية، مصر، 1975، ص ص 30-50 ..
3 : Organization for Economic cooperation and developpement (OECD), The Knowledge Based Economy ;1996.
4: أنظر محمود السيّد : قضايا راهنة للغة العربيّة، وزارة الثقافة – الهيئة العامّة السوريّة للكتاب، 2016.
5 voir le texte du Rapport dans le site :http://www.albankaldawli.org/ar/topic/education/overview ; visité le 13/01/2018, a 10heures.
6 : محمود السيد : „الاستثمار في اللغة العربية ثروة قومية في عالم المعرفة»، محاضرة علمية ألقيت في 27أيار2015، بمجمع اللغة العربية ، في الرابط : http://alwatan.sy/archives/4914، الذي تمت زيارته في 18/01/2018، على الساعة التاسعة.
7 : فلوريان كولماس: اللغة و الاقتصاد، ترجمة أحمد عوض ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت ،2000، ص 9.
8: المرجع نفسه، ص ص 9-12.
9 : زيتون محيا : التجارة بالتعليم في الوطن العربي– الإشكاليات و المخاطرو الرؤية المستقبلية ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت،2013،ص 23.
10 :Louis-Jean Calvet, Il était une fois 7 000 langues, Paris, Fayard, 2011, 267 p.
11 :Idem
12 :Organisation des Nations Unis pour l’Education, la Science et la Culture : „VITALITE ET DISPARITION DES LANGUES Groupe :d’experts spécial de l’UNESCO sur les langues en danger„ ; in https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d_ew9-7r2wEJ:https://ich.unesco.org/doc/src/00120-FR.pdf+&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=dz
13 : فلوريان كولماس ، المرجع السابق ، ص ص15-19.
14: نائف نبيل حاجي: „النقود صفاتها و خصائصها„، الحوار المتمدن – الإدارة والاقتصاد،2006، في الرابط http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=77752&r=0، الذي تمت زيارته يوم 8/03/2018، على الساعة العاشرة ونصف.
15:زيد بن محمد الرماني: اقتصاديات اللغة، في الرابط ،http://www.alukah.net/web/rommany/0/118434 ، الذي تمت زيارته يوم 8/03/2018، على الساعة العاشرة و نصف.
16:المرجع نفسه.
17: المرجع نفسه.