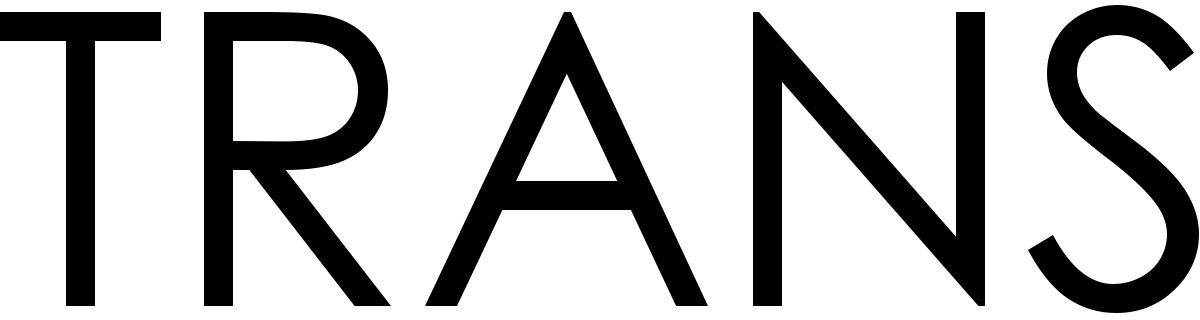بروال الطيب
طالب دكتوراه
قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة 1
BEROUAL Tayeb
Université de Batna 1
الملخص:
تعتبر الجامعة من أهم المؤسسات الاجتماعية في المجتمع، فهي المصدر الحقيقي للقوة والوسيلة الأساسية للتنمية، ونظرا للتحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وكذلك انتشار البطالة التي تشكل مشكلا يعيق التنمية الوطنية، يجب عليها مجارات هذا التطور والاستجابة لمتطلبات سوق العمل، لذا يشهد التعليم العالي بالجزائر إصلاحات متعاقبة، حيث مست العديد من الجوانب أهمها علاقة الجامعة بعالم الشغل الذي يركز على ربط التكوين الجامعي بالتشغيل، بغية تحقيق مستوى مقبول من المواءمة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل انطلاقا من ضمان تكوين نوعي يأخذ بعين الاعتبار تحضير الطلبة إلى عالم الشغل، قصد الاستجابة لحاجات سوق العمل الذي يشهد تحولا جذريا في مناصب العمل التي أصبحت متغيرة باستمرار وتتطلب كفاءات جديدة أهمها القدرة على التكيف معها.
Abstract:
The university is considered one of the most Important social institutions, it’s the true source of power and the basic means to development, due to economic and social, scientific, technological Transformations and changes And also the spread of unemployment. That’s considered a problem that Impedes national development it must keep up with it and Response to labor market requirements It‘ why The education sector in Algeria is witnessing consecutive reforms that touched many economical aspects, and most importantly the relationship between the university and the labor world that focuses on connecting the universal formation with employment to achieve an accepted level of adaption between university’s outputs and work requirements. Based on ensuring a qualitative formation that takes in consideration the preparation of student to labor world in order to response to the market needs wich is witnessing radical changes in work positions that become constantly variable and requires new competencies and most importantly the ability to adapt with it.
المقدمة
أصبح التعليم العالي مؤسسة هامة في مجتمعنا المتطلع إلى التقدم والتطور والنمو وعليه تقع مسؤولية نشر الثقافة العامة والإسهام في حل مشكلات المجتمع المحلية و على رأسها البطالة، من خلال الكوادر البشرية والبحوث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع، فلقد اعتمدت السياسة الجزائرية على مبدأ ديمقراطية التعليم و الذي تحقق عن طريق توسيع الجامعة والزيادة في عدد الطلبة حيث ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بشكل كبير، إلا أن الاهتمام بنظام التعليم العالي في الجزائر قد انحصر على نسبة الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الإنفاق بدلا من الاهتمام بنوعية التعليم و مدى مواءمته لسوق العمل، فتزايد أعداد الخريجين من الجامعات مقابل محدودية الوظائف في القطاع الحكومي، مما أدى ذلك إلى خلق مشاكل عديدة منها اختلال ما بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي وطلب سوق العمل و تفاقم مشكلة البطالة، وبناءا على ذلك نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل في الجزائر؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة سنتطرق لهذه المحاور:
أولا: واقع سوق الشغل في الجزائر.
ثانيا: البطالة والتعليم بين مخرجات التعليم ومدخلات الشغل.
(1) التعليم وتحدياته في الجزائر.
(2) العلاقة بين البطالة والتعليم.
(3) استراتيجية التعليم ودورها في تأهيل مناصب شغل مكيفة ومبرمجة.
ثالثا: سبل تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق الشغل.
أولا: واقع سوق الشغل في الجزائر
الطلب والعرض على الشغل في الجزائر عرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية نقائص وعجز كبير في التسيير، وإن محاولة المشرع الجزائري لإيجاد تنسيق في سوق الشغل الذي يعرف مرونة كبيرة تتطلب منه إستراتيجية فعالة و جد مدروسة آخذا بعين الاعتبار عدة العوامل التي تحدد في آن واحد العرض والطلب على العمل من هذه العوامل التغيرات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، متطلبات النهضة الاقتصادية و التنمية الاقتصادية التي تسعى لها الدولة، ومعدل النمو السكاني بالإضافة إلى انتشار التعليم بأشكاله فان لم يكن نوعا فالأكيد أنه يتزايد كما.
ويعتبر الطلب على العمل دالة لثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في كل من: ارتفاع معدل النمو السكاني، زيادة طلب المرأة على العمل، انتشار مستويات التعليم. وهناك عامل آخر ساهم في الزيادة في الطلب على العمل وهو عودة المتقاعدين إلى سوق العمل وكذلك دخول فئة الأطفال في سوق العمل بسبب تطور السوق الغير رسمي للعمل، هذه العوامل التي زادت في الطلب على العمل ألزمت على الدولة أخذ التدابير اللازمة ووضع السياسات و الاستراتيجيات المناسبة لخلق مناصب عمل جديدة و تقلل من نسبة البطالة في أوساط الشباب.i ويتميز هيكل السوق الجزائري للعمل بقطاعين هما: 1- قطاع ريفي يشمل جميع النشاطات الفلاحية والرعوية، 2- قطاع حضري يشمل نوعين من الممارسات المهنية الرسمية و غير الرسمية.
لقد كان القطاع الريفي يمتص ما يقرب من %73 من اليد العاملة لكن هذه النسبة تراجعت بفعل ظاهرة النزوح الريفي والهروب إلى المدن نتيجة ارتفاع الأجور فقد بلغت %42 سنة2003 ، هذه الظاهرة رفعت في مستوى الطلب على العمل في القطاع الرسمي و دفعت إلى بروز القطاع غير الرسمي. وقد اتجهت الدولة منذ 1990 إلى إحداث مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والقطاعية تهدف بالإضافة إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق وعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية الكلية وتوفير الشروط الملائمة للتنمية المستدامة وبالتالي زيادة الطاقات للقطاعات المحلية في عرض العمل وامتصاص البطالة.
وقد شرعت الجزائر في إصلاحات اقتصادية واسعة بعد انتهاء عهد الاقتصاد الموجه في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، هذه الإصلاحات مست القطاع العام في إطار برنامج التصحيح الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى خوصصة مؤسسات القطاع العام ونتج عن هذا البرنامج تسريح عدد كبير من العمال أفقد حوالي 400000 عامل لمنصبهم. هذه الإصلاحات أدت لانتعاش القطاع الخاص على حساب القطاع العام حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف القطاع الخاص سنة 1999 إلى 7384 مؤسسة مقابل 14 مؤسسة فقط في القطاع العام أي استحوذ القطاع الخاص على 99% تقريبا من مجمل المؤسسات على المستوى الوطني.
لقد تراجع العرض على العمل في القطاع ألفلاحي من 21% سنة 2001 إلى 18% سنة 2006. أما الصناعة فلم يعرف فيها العرض على العمل أي تحسن بل تراجع في هذه الفترة, فقد بلغ سنة 2002 نسبة 9.2%، و بالنسبة لقطاع الشغال العمومية فقد عرف فيها التشغيل ارتفاعا محسوسا انتقل من%10.44 في 2001 إلى %14.2 سنة 2006 و يعود هذا التحسن في القطاع للاستثمارات الضخمة التي رصدتها الحكومة لتقوية البنية التحتية و الهياكل القاعدية للاقتصاد الوطني من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي لسنة 2001 و الذي خصص له 525 مليار دينار على امتداد أربع سنوات، أما قطاع التجارة و الخدمات فقد مثل حوالي %54 من الفئة النشيطة في الدولة.ii
ثانيا: البطالة والتعليم بين مخرجات التعليم ومدخلات الشغل.
الاقتصاد الوطني يعاني أكبر نقص في الإطارات، لذا وجب استحداث تخصصات علمية تكون مواكبة لاحتياجات التنمية و سوق العمل، لذلك فالجزائر تطبق سياسة الانفتاح في عدة تخصصات، و من ثم وجب على الجامعة أن تعمل على توجيه الطلبة نحو مجالات التكوين حيث يعاني الاقتصاد الوطني أكبر نقص في الإطارات، واستحداث تخصصات علمية تكون مواكبة لاحتياجات التنمية.
(1) التعليم وتحدياته في الجزائر
تضم الشبكة الجامعية الجزائرية ثلاثة وستين (63) مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على ثلاثة وأربعين (43) ولاية عبر التراب الوطني، وتضم سبعة وعشرون (27) جامعة وعشرون (20) مركزا جامعيا واثنتا عشر (12) مدرسة وطنية عليا وأربعة (04) مدارس عليا للأساتذة، مع العلم أن مؤسسات التكوين العالي لم تأخذ في الحسبان ضمن هذا التعداد، كما توجد مدارس ومعاهد تخضع لوصاية قطاعات وزارية خارج قطاع التعليم العالي هي قطاعات اقتصادية منتجة.
أما بالنسبة للغة التدريس هي اللغة العربية في التخصصات الأدبية واللغة الفرنسية في التخصصات العلمية والتكنولوجية والطب، ويتمنى الطلبة والتلاميذ الجزائريون أن يتم إدراج اللغة الإنجليزية لتحل محل اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى في التعليم بكل أطواره. وقد غيرت الجامعات مناهجها مرحليا و تدريجيا إلى النظام الجديد (LMD) على الرغم من قوته لم يفز برضى جميع الطلبة حاليا لعدم وفرة الوسائل و الإمكانيات اللازمة لإنجاحه هذا ما جعله يصطدم بالنظام الكلاسيكي و بقوة مما خلق أزمة حادة.iii
فيما تعلق بميزانية قطاع التعليم العالي في الجزائر فهي في تطور مستمر، حيث تضاعفت بحوالي 7 مرات منذ سنة 2000 إلى غاية 2014، وهذا ما يوضح اهتمام الدولة بقطاع التعليم العالي باعتباره منبع الكفاءات المؤهلة لتسيير الدولة ونلاحظ كذلك تطور عدد الطلبة المسجلين في هذا القطاع وأيضا نصيب كل طالب من الاعتمادات المخصصة، حيث تضاعف نصيب الطالب من حصة الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع منذ سنة 2000 من 90.007 دج ليصل إلى 212.014 دج سنة 2014، إلا أن الاهتمام بالإنفاق دون النظر إلى احتياجات المجتمع من التخصصات الفنية الأخرى أدى إلى زيادة أعداد الخريجين من ذوي المؤهلات عن الحد المطلوب للمجتمع وارتفاع معدلات البطالة، فالواقع يؤكد ارتفاع بطالة فئة الخريجين الجامعين، وذلك لعدم وجود توازن بين مخرجات التعليم و طلب سوق العمل، حيث يلاحظ وجود فائض في بعض التخصصات وعجز في بعضها الآخر، حيث توجد فجوة كبيرة بين ما يتلقاه الشباب من التعليم و التدريب وبين احتياجات سوق العمل ومتطلباته.iv
وتواجه الجزائر كغيرها من الدول العربية مجموعة من التحديات يمكن تلخيصها في الآتي:
-
الطلب المتزايد على التعليم العالي وتزايد أعداد الطلبة حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين 1.277.000 طالب سنة 2014.
-
قلة التأطير حيث قدر عدد الأساتذة المؤطرين للطلبة سنة 2011 بـ 40.140 أستاذ دائم أغلبهم برتبة أستاذ مساعد 28.782 (أستاذ مساعد) كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي (بروفسور) على أبواب التقاعد.
-
نمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث لا تفتح المجال للإبداع.
-
التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي و ذلك للتكلفة التي أصبح يتطلبها التعليم إضافة إلى تغير منظومة القيم المجتمعية بحيث لم يبقى للتعليم نفس المكانة المرموقة التي كان يحظى بها في السابق.
-
هجرة الكفاءات وعدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطير والتكوين.
-
-
البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نيل الشهادات وليست بحوث تنجز بهدف التطبيق العملي لها مما أدى إلى الحد من فعالية البحث العلمي.
-
-
-
تنامي معدل البطالة بين خريجي الجامعات.v
-
-
-
و يمثل التحدي الأساسي الذي يواجه نظام التعليم في الجزائر: في توفير عرض مناسب من الخبرات و المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، و الحرص على الارتقاء بمستوى هذا العرض بصورة مستمرة، وضرورة دعم التزام مؤسسات المجتمع المختلفة بأهمية تطوير الموارد البشرية للحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنتاجية و التوظيف، وأيضا كيفية حل المشكلات الأكاديمية و الإدارية التي تواجه مؤسساتنا التعليمية، و ضرورة تبني هياكل جديدة للبرامج الدراسية ذات محتوى يتناسب مع طبيعة المراحل المقبلة و يرتكز على تنمية جوانب الإبداع لدى الطلبة مثل استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، و كذا مشكلة توفير الخدمة التعليمية على نطاق واسع لعدد متزايد من المواطنين و في الوقت ذاته توفير مستوى مرتفع من التدريب و كذلك البحوث سواء على المستوى الجامعي أو الدراسات العليا، مثل الاستعانة بالتعليم المفتوح أو التعليم عن بعد كبديل و أحيانا كمكمل للدراسة التقليدية على اعتبارهما وسيلة اقتصادية لنشر التعليم.vi
-
لقد قطعت الجزائر شوطا كبيرا في ذلك، حيث تم إدخال طرائق جديدة للتكوين والتعليم، تتضمن إجراءات بيداغوجية جديدة خلال مسار التكوين، لهذا تم إطلاق المشروع الوطني للتعليم عن بعد، و يرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات المرئية و التعليم الالكتروني موزعة على غالبية مؤسسات التكوين، و الدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طريق الشبكة الوطنية للبحث (ARN)، حيث يوجد حاليا سبعة و سبعون(77) مؤسسة معنية بالمشروع، و يعد مركز البحث العلمي و التقني (CERIST) النقطة المركزية في المشروع، أما بالنسبة للمحاضرات المرئية فهناك ثلاثة عشرة (13) موقع مرسل / مستقبل و أربعة و ستون (64) موقعا مستقبلا.vii
ولتطوير التعليم والوصول إلى ركب الدول المتقدمة فهناك ثلاثة توجهات إستراتيجية يجب أن تتبعها الجزائر وتتمثل بالآتي:
-
-
بناء رأس مال بشري راقي النوعية بما يؤدي إلى تبلور مسار للحداثة والتمييز، صياغة علاقة تضافر قوية بين التعليم والمنظومة الاجتماعية الاقتصادية، إقامة برنامج لتطوير التعليم للمواءمة بين التعليم والعمل.viii
-
بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في تطوير التعليم من خلال الوسائط المتعددة، التكنولوجيا النقالة، الانترنت، ثورة الاتصالات، وقطعت الجزائر شوطا كبيرا فيما يخص تكنولوجيا المعلومات حيث أصبحت الجزائر الآن تنفق لتطوير تكنولوجيات جديدة وخصوصا في مجال تقنية المعلومات والطاقات المتجددة وكذا الاهتمام بالجامعة نظرا لدورها في تعزيز المعرفة ببرامج وأنشطة البحث والتطوير، حيث خصصت الحكومة الجزائرية لذلك غلافا ماليا يقدر ب 250 مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة ضمن برنامج الإنعاش الخماسي 2010-2014.ix
-
(2) العلاقة بين البطالة والتعليم
يؤثر التعليم تأثيرا ضعيفا على البطالة، لكن يمكن أن يكون للبطالة أثر كبير في الطلب على المزيد من التعليم، إذ يؤدي انخفاض البطالة إلى انخفاض الطلب على التعليم، وذلك لأنه عندما تنخفض البطالة، يرتفع ضياع مداخيل الأفراد بمكوثهم في المدرسة للحصول على تعليم عالي، فإنه من المحتمل جدا أن ينتج عن انخفاض معدل البطالة تقّلص الفوارق بين مداخيل الأفراد الأقل تعليمًا والأكثر تعليمًا، وبالتالي ستنخفض الفائدة المادية من الذهاب بعيدًا في التعليم العالي.
وهكذا ينتج عن انخفاض معدل البطالة انخفاض الطلب على التعليم العالي، ويرتبط ارتفاع الطلب على التعليم العالي بتقلص فرص الشغل أو انعدامها بالنسبة إلى الشباب، فالشاب الذي يفشل بعد إتمام التعليم الثانوي في الحصول على عمل، يجد نفسه مضطرًا إلى ولوج الجامعة دون رغبة منه (البطالة الكامنة)، كما أن بطالة حملة الشهادة الجامعية وغيرها، تؤدي بأغلبهم إلى الإقبال على متابعة الدراسات العليا، حتى وإن كانوا أصلا غير راغبين فيها أو غير مؤهلين لها.x
(3) استراتيجية التعليم ودورها في تأهيل مناصب شغل مكيفة ومبرمجة
يفترض المخططون عن خطأ، أن المشكل كامن في العرض وحده، أي أن المهارات التي تكتسب في المدرسة ليست ملائمة لسوق الشغل، فليس هناك دليل مادي على صحة الافتراضات والإجراءات السالفة الذكر، وإنما ينم كل واحد منها عن فهم غير سليم لسوق الشغل في هذه البلدان.xi
إن المشكل هو مشكل عرض وطلب في آن واحد، ولا يمكن إنتاج يد عاملة متعلمة أن يحل مشكل البطالة، إلا إذا تم ذلك في تلازم مع ارتفاع الطلب على هذه اليد العاملة المتعلمة، وقد أشار فوستر Foster Philip إلى أن إصلاح المنهاج الدراسي لن يغير وحده الوضعية الحالية، إذ ليست الأسباب المؤدية إلى تقليص تشغيل القوى البشرية ذات علاقة فقط بما يدرس في المدارس، وأكثر من ذلك فإن المستويات التعليمية المتدنية لا تؤهل الأفراد للقيام بأعمال متخصصة ومحددة، وحسب وجهة نظر فوستر هناك استراتيجيات يمكن إتباعها، استراتيجيات ترتكز على فحص ما يجري خارج المدرسة، أكثر من ارتكازها على تحليل ما يجري داخلها.xii أما فيما يتعلق بالافتراض الذي يرى أن المدرسة تستطيع إقناع الناس بالرغبة في مزاولة بعض المهن من خلال تدريبهم عليها، فإن حوافز الطلاب والتلاميذ تتأثر بالتصورات التي يكونوها حول مختلف فرص العمل المتوفرة، وتتولد هذه التصورات من واقع المحيط السوسيو اقتصادي.
والمدرسة لا تستطيع أن تولد لدى الناس رغبة في بعض المهن، إذا كانت تقودهم إلى البطالة أو تجعلهم يحصلون على دخل منخفض وامتيازات أقل. ويفشل أولئك الذين ينتقدون الطبيعة „التقليدية“ للطلب على التعليم الأكاديمي، ويعتبرونه نقيضًا للتكوين المهني، في الاعتراف بأن قوة الأول تكمن أساسًا في أنه هو كذلك في نهاية الأمر، تكوين مهني يمكن من ولوج المناصب المهمة التي يتقاضى أصحابها أجورًا محترمة، ليست البطالة ناجمة عن كم التعليم المحصل عليه من قبل القوى العاملة أو نوعه، وعندما يحصل تحسن هامشي من خلال إصلاح المنهاج الدراسي، أو محاولة استدراج الناس إلى مهن يظهر أن هناك طلبًا عليها، فإنه سرعان ما يختفي هذا الطلب، ويتجاوزه العرض، ويظل مشكل البطالة قائمًا، وإذا كان المقررون الرأسماليون سيشغلون عددًا من المستخدمين، فإن حجم هؤلاء لن يرتفع بجل التكوين أكثر ملائمة، وهكذا فإن مشكلة المشرع الجزائري أنه لا يرجع مشكل البطالة إلى النظام التعليمي، ومع ذلك نجد أن المخططين يضعون دائمًا حلولا تعليمية لتشوهات متأصلة في الاقتصاد ومتجذرة فيه.xiii
يقتضي حل مشكل البطالة فحصًا شموليًا للعرض والطلب، ويتحدد الطلب على القوى البشرية في الاقتصاد الوطني بناءا على عدد المستخدمين الذين يرغب المسؤولين على الاقتصاد في توظيفهم، ويرتبط هذا من الناحية النظرية، بتكلفة اليد العاملة والتكنولوجيا المستعملة، فلقد بينت أن أرباب المؤسسات الاقتصادية يفضلون التكنولوجيا التي توظف يدًا عاملة أقل، كما أن اختيار السلع التي يجب إنتاجها، لا يتم اتخاذه أساسًا وبالدرجة الأولى بناء على طلب المستهلك، بل يتجه أرباب الرأسمال المادي نحو إنتاج السلع التي يقتضي إنتاجها استعمالا أكثر للرأسمال المادي، وهكذا فمن أجل رفع الطلب على قوى العمل وضمان النمو، يجب إعادة النظر في طريقة اتخاذ القرار الاقتصادي وصيغه، وبالتالي إعادة النظر في الرؤية الاجتماعية لمسيري الاقتصاد.
على مستوى العرض، يجب أخذ معدلات النمو السكاني بعين الاعتبار، إذ بقدر ما يستمر النمو السكاني في الانفجار، بقدر ما يمتص تعليم الأعداد الهائلة المتزايدة من الأفراد وتشغيلها طاقات أغلب البلدان، كما أن العمل على تخفيض معدلات النمو السكاني يساعد على توفير التعليم لأغلب أفراد المجتمع وتشغيلهم، وفي حالة أغلب البلدان تؤدي شروط طلب الشغل وكذا ضعف تنظيم العمل حتى في حالة انخفاض معدل نمو السكان وارتفاع مستويات اليد العاملة والناتج الوطني الإجمالي إلى عدم انخفاض معدلات البطالة الحاليةxiv.
وخلاصة القول، إنه يجب تركيز البحث في البطالة على التشغيل الكامل لقوى العمل، فليس هناك منطق أو حجة مادية تؤكد أن توفر قوى عاملة كثيرة ذات مستويات تعليمية عالية سيخلق عملا أكثر، إلا إذا كانت قرارات الإنتاج والاستثمار بيد العمال أنفسهم، وفي هذه الحالة فإن القوى العاملة المتعلمة تعليمًا جيدًا والواعية، ستكون مؤهلة لإيجاد عمل قائم على استعمال تقنيات تستدعي توظيف أعداد كبيرة من اليد العاملة، لكن حدوث هذا ونجاحه في دولة مثل الجزائر غير مضمون.
ثالثا: سبل تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق الشغل.
تسعى الدولة جاهدة لوضع قنوات بين مخرجات التعليم و مناصب الشغل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بإتباعها الإجراءات التالية:
-
بتشجيع المبادرة المقاولاتية لدى الشباب لتجسيد أكبر عدد من المؤسسات المصغرة في إطار تدعيم مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المسطرة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
-
تخصيص هذه الفئة جهاز عقود ما قبل التشغيل كآلية لدعم إدماجهم مهنيا ومرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطات تكوين وإعادة تأهيل وتحسين المعارف خلال فترة الإدماج.
-
تمر الجزائر بتحولات اقتصادية كبرى حيث تعيش مرحلة انتقالية من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق، تولدت عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، وفي هذا الإطار اتخذت جملة من الترتيبات كتحسين التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتدعيم وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وتتميز هذه المرحلة بتطور القطاع الخاص الذي يتطلب يد عاملة مؤهلة كون أن نوعية الموارد البشرية تلعب دور مصيري بالنسبة للمؤسسة في ظل محيط تنافسي.
-
تبني النظام الجديد في الجامعات الجزائرية للرفع من مستوى الطلب على العمل المتخصص والدقيق ومن اجل وضع علاقة مستقرة بين مخرجات التعليم و مدخلات العمل.
الخاتمة:
إن ارتفاع معدل البطالة بين المتعلمين يدل على أن سياسات التنمية في الجزائر متحيزة لغير المتعلمين، بالإضافة إلى مشكلة عدم التوازن بين أنواع التعليم والاحتياجات الاقتصادية و عدم التنسيق بين التخطيط التعليمي والتخطيط الاقتصادي بحيث أصبح النمو السنوي للخريجين أكثر من نمو الوظائف الجديدة، فالتعليم في الجزائر ركز على جانب العرض بمعنى أنه أفرز خريجين لا يحتاج إليهم سوق العمل، ونتج عن ذلك بطالة خريجي الجامعات ونقص تشغيلهم و بصفة خاصة بين المتخصصين في الآداب و العلوم الاجتماعية و العلوم الإنسانية التي تعتمد في توظيفها على المؤسسات العمومية، مما أدى بروز ظاهرة هجرة الأدمغة إلى الدول المتقدمة.
وكما أن افتقاد نظام التعليم لطابعه التكويني والمهني وعدم التنسيق بين السياسات التعليمية والتوظيف كان سببا في الاختلال الحاصل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ويجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الجزائر في قطاع التعليم يحتاج إلى المراجعة بحيث يصبح المعيار هو الكيف والجودة وليس الكم مثل ما نشهد.
i دحماني أدريوش، بوطالب قويدر، فعالية نظام التعليم و التكوين في الجزائر و انعكاسه على معدلات البطالة ، المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية، القاهرة، 2008ص 159.
ii شيبي عبد الرحيم و شكوري محمد، البطالة في الجزائر مقاربة تحليلية و قياسية، المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية، القاهرة، 1988، ص 85.
iii أحمد الكواز، السياسات الاقتصادية و رأس المال البشري، دراسة ميدانية مقدمة حول „العلاقة بين التعليم و سوق العمل وقياس عوائد الاستثمار البشري، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2002، ص 180.
iv مهدية ستردون، إشكالية انتقال رأس المال البشري العربي البيني في ظل إمكانيات التكامل الاقتصادي العربي، مذكرة ماجستير غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة الشلف، 2010، ص 114.
v ناصر الدين قريبي، مواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل في الجزائر –دراسة استكشافية–، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، جامعة وهران، العدد الرابع، ديسمبر 2015، ص 154-155.
vi يوسف احمد الإبراهيم، تنمية الموارد البشرية في اقتصاد مبني على المعرفة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة،2004 ، ص 108-110.
vii ناصر الدين قريبي، مرجع سبق ذكره، ص 155.
viii محمد عواد الزيات، اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2008 ، ص 268.
ix ناصر الدين قريبي، أثر الصادرات على النمو الاقتصادي – دراسة حالة الجزائر–، مذكرة ماجستير غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة وهران، الجزائر،2014 ، ص 115.
x أيدار عائشة، سياسات إصلاح التعليم العالي وسوق الشغل في الجزائر: واقع وتحديات، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 13، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، جوان 2015، ص 127.
xi السيد عبد العزيز الهواشي وسعيد بن حمد الربيعي، ضمان الجودة في التعليم العالي، ط 1، عالم الكتاب، القاهرة، 2005 ، ص 23.
xii أيدار عائشة، مرجع سبق ذكره، ص 127.
xiii عبد الله جمعة الكبيسي، دور مؤسسات التعليم العالي، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، قطر، ط 1، سنة 2001، ص 225.
xiv السيد عبد العزيز البهواش، ضمان الجودة في التعليم العالي، عالم الكتب، القاهرة، مصر،2005 ، ص 05.