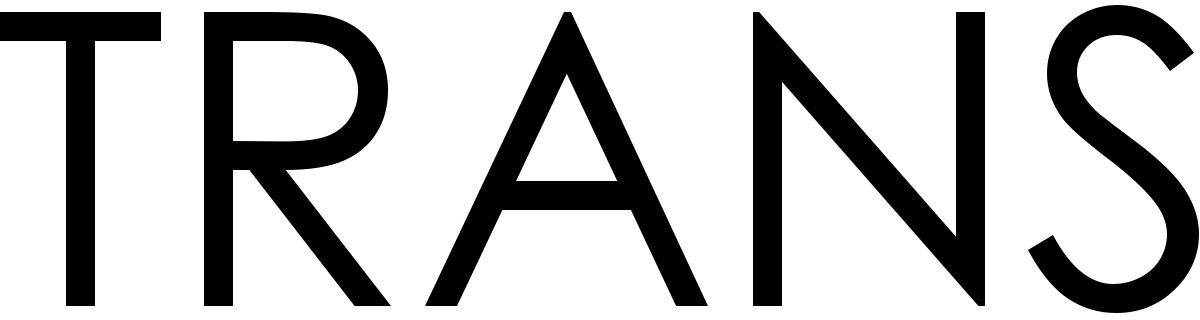Ibrahim ZERROUKI
University Oran 2
تطرح سياسة التشغيل كأداة تنظيمية مفهوم تحكمه عدة مرجعيات تتمثل أساساً في الجانب الاقتصادي، الاجتماعي وحتى الثقافي والفكري بل وحتى الفني؛ وضمن هذا المسعى يبرز دور القانون في صورة السلطة التشريعية، حيث من خلاله يتم رسم الأطر السياسية التي تسيَّر عبرها مختلف القطاعات خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالتشغيل.
على ما بدا آنفاً، تلعب صياغة النص التشريعي من الناحية اللغوية عاملاً حاسماً في تحديد التوجُّهات التي يرغب في بلوغها أي قطاع، حيث تسمح لنا الصياغة الواضحة والدقيقة للنص التشريعي بفهم مغزى القانون المزمع تطبيقه، وليس أدلَّ من ذلك من الإتيان بأمثلةٍ توطِّد ما أتينا على ذكره؛ إذ في هذا المضمار نجد أن المشرع الجزائري يستعمل مصطلح موظف للدلالة عن الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية، بينما يستعمل مصطلح عامل للدلالة عن الأشخاص العاملين في المؤسسات الخاصة، غير أن هذان المصطلحان يعتريهما بعض من اللبس حين الرجوع إلى سياق النصوص التي يستعملان فيها، إذ أن المشرع الجزائري وهو بصدد تعريف العامل ضمن المرسوم التشريعي رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتعلِّق بعلاقات العمل، نصَّ في المادة02 منه على ما يلي:“يعتبر عمَّالاً أجراء، في مفهوم هذا القانون، كل الأشخاص، الذين يؤدون عملاً يدوياً أو فكرياً مقابل مرتب، في إطار التنظيم، ولحساب شخص آخر، طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، يدعى „المستخدم„.
إن المتمعن لعبارة„ولحساب شخص آخر، طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص„، يَلْحَظُ أن المشرع الجزائري أدرج مصطلح عمومي، وهو مصطلح يبدو لأوَّل وهلة في غير محله، كون أن العمَّال في الهيئات العمومية يعتبرون موظفين بحكم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، المتضمِّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أن المشرع الجزائري يقصد بذلك العامل الذي يشتغل بالشركات التجارية والصناعية التي تؤدي الخدمة بمقابل، وليس الموظف المشتغل بالمؤسسات العمومية الإدارية على شكل البلدية والولاية وغيرهما التي تؤدي الخدمة مجاناً.
مقدٍّمة:
سعت الجزائر مند الاستقلال إلى رسم سياسة تشريعية تتناسب ومتطلبات المسار الاقتصادي المتبنى، القائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وقد اهتمت بصفة كبيرة وفقاً لذلك بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، وهو ما تعكسه المشاريع الكبرى التي برمجت آنذاك في قطاعي الصناعة والفلاحة، غير أنه ونتيجة تنامي الطالب على الشغل بفعل النمو الديموغرافي المضطرد، استدعى الوضع الاستعانة بالقطاع الخاص للمساهمة بدوره في حركة النمو الاقتصادي. وهو ما يعكسه القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، المتعلِّق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، حيث جاء في المادة 08 منه ما يلي: في إطار مسار التنمية الوطنية وطبقاً للميثاق الوطني، تتمثل الأهداف المنوطة بالاستثمار الاقتصادية الخاصة فيما يلي:
-
المساهمة في توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية وفي إنشاء مناصب للعمل وتعبئة الادخار وتلبية حاجيات المواطنين من المواد والخدمات…“(1).
بناءً على ما جاءت به المادة 08 السالفة الذكر، يتضح بأن المشرع الجزائري قد تنبه لدور القطاع الخاص في المساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق مناصب عمل، غير أن وثيرة تطبيق هذا القانون اتسمت بالبطء بفعل عدة عوامل أبرزها الوضع الاقتصادي الذي طرأ وقتئذٍ. بعد صدور دستور سنة 1989 ودخول الجزائر مسار اقتصاد السوق القائم على حرية الاستثمار والمنافسة، سعى المشرع الجزائري إلى إصدار نصوص قانونية تتلاءم ومقتضيات الدستور السالف الذكر لاسيما في ميدان التشغيل(2).
وعليه، فان المشرع الجزائري أصدر المرسوم التشريعي رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990، المتعلٍّق بعلاقات العمل، الذي خصَّ به العمال المشتغلين في القطاع الخاص(3)، ثم بعد مدة أصدر الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، المتضمِّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية(4)؛ فضلاً عن إصدار لجملة من التظيمات التي تعنى بقطاع التشغيل كنحو المرسوم التشريعي رقم 96-297 المؤرخ في 08 سبتمبر سنة 1996، المعدَّل والمتمَّم بالمرسوم التنفيذي رقم 11-102 المؤرخ في 06 مارس سنة 2011، المتضمٍّن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أبريل سنة 2008، المتعلِّق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني(5).
وفق ما تقدَّم فان النصوص التشريعية الصادرة عن المشرع الجزائري عموماً والواردة على قطاع الشغل خصوصاً تحمل في مضمونها مصطلحات عديدة، تعتبر كأداة لغوية تسمح بصناعة نص قانوني يهدف إلى تأطير سياسة المشرع الجزائري في مجال التشغيل، وتحقيق تطبيقٍ سليم لمضمون هذه النصوص بما يتوافق مع مقتضيات سياسة التشغيل المنتهجة، فضلاً عن الاستعانة أو خلق بمصطلحات جديدة تتناسب مع المعطيات الاقتصادية المتسمة بالتطور المضطرد؛ وبهذا نطرح الإشكالية التي ما فادها ما يلي:
الصياغة القانونية ودورها في خدمة ميدان التشغيل؟
لمعالجة الإشكالية السالفة الذكر نقترح درستها ضمن المخطط التالي:
أوَّلاً: خدمة المصطلح اللغوي الدقيق في ميدان تشريع العمل
ثانياً: دمج المصطلحات الحديثة في تشريع العمل
أوَّلاً: خدمة المصطلح اللغوي الدقيق في ميدان تشريع العمل
يسمح استعمال المصطلح التشريعي الدقيق في مختلف القطاعات بما فيها قطاع العمل من تسطير سياسة تشغيلية فعَّالة، وذلك من خلال تضمين ألفاظ تفيد المعنى المراد الوصول إليه، ما يرفع اللبس أثناء المبادرة إلى تطبيق النص القانوني، وهو ما من شأنه درأ النزاعات التي قد تثار بمناسبة ذلك؛ غير أنه في هذا المضمار قد يطرأ في التشريع الجزائري بعض من الإشكالات أهمها ازدواجية اللغة في صناعة التشريع.
– مضمون تشريع العمل
اعتنى المشرع الجزائري بقطاع التشغيل، وأصدر في سبيل ذلك عدة قوانين على رأسها المرسوم التشريعي رقم 90-11، الذي خصصه المشرع الجزائري لفئة العمال المشتغلين في القطاع الخاص بمختلف أشكاله، حيث يُعنى هذا التشريع بمسار المهني للعامل من يوم دخوله مجال العمل إلى غاية انتهاء علاقة العمل بينه وبين المستخدم، وكذا الأمر رقم 06-03 السالفين الذكر، الذي أفرده المشرع الجزائري لفئة العمال المشتغلين في القطاع العام، ويُعنى هو الأخر بنفس ما يُعنى به القانون رقم 90-11 المذكور أعلاه(6).
هذا وقد استعمل المشرع مصطلح عامل للدلالة على الشخص المشتغل لدا القطاع الخاص، واستعمل مصطلح موظف للدلالة على الشخص المشتغل لدا القطاع العام.
– تأثير ازدواجية اللغة على تشريع العمل
تعتبر اللغة العربية في التشريع الجزائري اللغة الرسمية والأصلية التي من خلالها يصاغ النص القانوني، لكن في العديد من المرات يطرأ لبسٌ في فهم بعض المصطلحات أو العبارات المصاغة باللغة العربية، ما يقتضي الرجوع إلى النص التشريعي بنسخته الفرنسية لفهم فحوى النص، وهذا لعدة عوامل هي كالآتي:
-
تأثير اللغة الفرنسية من خلال المدرسة اللاتينو رومانية على التشريع الجزائري بفعل الاستعمار.
-
وضوح المصطلح الفرنسي مقارنة بالمصطلح العربي بفعل التكرار والاستعمال اليومي.
-
التوظيف اللغوي للمصطلح الفرنسي في جميع المجالات خاصة العلمية منها(7).
كمثال عن ذلك: نأخذ مصطلح الموظف (fonctionnaire) أو عامل(Employé)(8).
ثانياً: تأثير النص التشريعي على صيغ التشغيل
يتم توظيف الراغبين في الشغل في الجزائر من خلال عدة طرق أهمها وفق قانون العمل من خلال التوظيف المباشر أو من خلال امتحان، ومن خلال قانون الوظيفية العمومية من خلال المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان، إضافة إلى مختلف هيئات التشغيل بمختلف أشكالها.
– قانون العمل وقانون الوظيفة العمومية
يتعاقد المستخدم ممثلاً في ربِّ العمل (القطاع الخاص) مع الراغبين في العمل من خلال نوعين من العقود، عقود محددة المدة(CDD) وعقود غير محددة المدة(CDI)، فبالنسبة للأولى فان التشغيل يتم من خلال عقود عمل تحدَّد فترة العمل فيها لمدة معينة مثل ثلاثة (03) سنوات أو أربع (04) سنوات كمثل المهن الموسمية، أما العقود غير محددة المدة فهي العقود التي تكون فيها فترة العمل غير مقترنة بمدة محددة على شكل مناصب عملٍ دائمة(9).
أما بالنسبة للوظيفة العمومي فيتم التوظيف فيها من خلال إعلان الهيئة العمومية عن فتح مناصب عمل وفق إجراءين إما عل أساس الشهادة أو على أساس المسابق من خلال امتحان كتابي في بعض من المواضيع المقترحة تتحدَّد بالأساس من قبل الهيئة الراغبة في التوظيف(10).
– هيئات التشغيل
بجانب أشكال التشغيل السالفة الذكر فان المشرع الجزائري استحدث أشكلاً أخرى بغرض توظيف الراغبين في الحصول على شغل، وهو ما يتمثل في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا جهاز المساعدة على الإدماج المهني(11).
هذا وتعمل الوكالة الوطنية لدعم التشغيل الشباب على مرافقة الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية، وكذا مساعدتهم على الحصول على قروض ومساعدة مالية بنكية، كما تعمل على ترقية وسائل التشغيل وإتاحة المعلومة الاقتصادية والتقنية للراغبين في ذلك(12).
أما بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد وجهه المشرع الجزائري لثلاثة فئات من الشباب هي:
-
خريجي الجامعات والمعاهد،
-
خريجي الثانويات ومؤسسات التكوين المهني،
-
الشباب من دون تكوين أو تأهيل(13).
خاتمة:
تلعب صياغة النص التشريعي بطريقة دقيقة دوراً محورياً في تحديد سياسة التشغيل المنتهجة من قبل المشرع، إذ من خلال ذلك يمكن لنا فهم أهداف المشرع الجزائري في ميدان التشغيل، لاسيما مع ما تتيحه أجهزة التشغيل المختلفة ضمن هذا المضمار. إن المتمعن لصياغة النص التشريعي في الجزائر يتبيَّن له بأن مخططات التشغيل في الجزائر تصنع وفق نظام قانوني مصاغ بطريقة لغوية دقيقة ومضبوطة في إطارها العام، ما يرفع اللبس عن جزء منها، لكن أحيانا يواجه الأشخاص القائمين على تنفيذ هذه القوانين ميدانياً جملةً من العراقيل نتيجة غموض بعضٍ من هذه النصوص.
لابد أن تكون صناعة النص التشريعي ممزوجة بين الأهداف المراد الوصول ليها وبين ما هو حاصل في الواقع العملي المرجو أن تطبق القوانين عليه، وهذا بغية وضع النص التشريعي ضمن الإطار الذي أُريد له أن ينظمه ويضبطه حتى لا يكون أداةً دون فائدة.
الهوامش:
(1)- أنظر القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، المتعلِّق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
(2)- أنظر دستور سنة 1989
(3)- أنظر المرسوم التشريعي رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990، المتعلٍّق بعلاقات العمل، الذي خصَّ به العمال المشتغلين في القطاع الخاص
(4)- أنظر الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، المتضمِّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
(5)- أنظر المرسوم التشريعي رقم 96-297 المؤرخ في 08 سبتمبر سنة 1996، المعدَّل والمتمَّم بالمرسوم التنفيذي رقم 11-102 المؤرخ في 06 مارس سنة 2011، المتضمٍّن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أبريل سنة 2008، المتعلِّق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
(6)- أنظر الأمر رقم 06-03 والمرسوم التشريعي رقم 90-11 السالفين الذكر.
(7)- وذلك بفعل الاستعمار الفرنسي الذي أثر بشكل كبير على المنظومة العلمية في الجزائر.
(8)- أنظر الأمر رقم 06-03 والمرسوم التشريعي رقم 90-11 السالفين الذكر.
(9)- أنظر المرسوم التشريعي رقم 96-297 السالف الذكر.
(10)- أنظر الأمر رقم 06-03 السالف الذكر.
(11)- أنظر المرسوم التشريعي رقم 96-297، المعدَّل والمتمَّم بالمرسوم التنفيذي رقم 11-102 السالف الذكر.
(12)- أنظر المرسوم التشريعي رقم 96-297، المعدَّل والمتمَّم بالمرسوم التنفيذي رقم 11-102 السالف الذكر.
(13)- أنظر المرسوم التنفيذي رقم 08-126 السالف الذكر.